كانت ساعتي تشير إلى العاشرة ليلاً عندما خرجتُ من منزل صديقي (أحمد) الذي يسكن في حي الشاغور بدمشق، كانت أولى زيارة لي لحارات أقدم مدينة مأهولة في التاريخ.. ورغم إصرار صديقي على مرافقته لي ريثما أصل لأقرب مركز لسيارات الأجرة، إلا أنني رفضتُ ذلك مبرراً بأنني لن أضيع.
بينما كنتُ أسير في الحارات الضيقة، رحتُ أتأمل الأبنية القديمة التي تحاصرني من كل جنب بأبوابها ونوافذها الخشبية وألوانها الداكنة، الصمت يلف المكان باستثناء خطواتي على الأرضية الملبسة بحجارة على شكل مربعات منفصلة.
لا شيء كان يسير معي سوى ظلي المتقطع بين الجدران المتشققة والأرضية، تذكرتُ مسلسلات دمشقية عديدة استلهمت من تلك الديكورات أماكن تصوير لها، وظننتُ نفسي حارس البوابة، لكن ما قطع عليّ شرودي وصولي لحارة مظلمة طويلة لم أعلم بدايتها من نهايتها، لأصل إلى قرار ألا وهو أنني ضعت.
نظرتُ إلى الأعلى أتأمل الغيوم في يوم شتائي بارد، أحشو يديّ في جيبيّ سترتي السوداء، وإذ بقدمي اليسرى تتعثر بجسم حسبته علبة كولا فارغة، لكن رنينه اخترق حاجز الصمت ما جعلني أتفحصه، انحنيتُ للأسفل وحملته، وفجأة تذكرت كتاب "ألف ليلة وليلة" الذي كنتُ أقرأه كل ليلة قبل أن أنام.
وسط قلق اعتراني في ساعة متأخرة، مددتُ يدي الأخرى لجيب بنطلوني القماشي الأسود لأتصل مع صديقي، فوجئتُ بعدم وجوده وتذكرتُ على الفور الطاولة التي كنت وضعتُ عليها هاتفي.
كان ذلك الجسم يشبه مصباح علاء الدين السحري، لم يخلُ من تراكم الأوحال عليه لتغطي لونه الأصفر الذهبي، وضعتُه في جيب السترة الأيمن لأحتفظ به بين أغراضي القديمة، وقبل أن يحتك بسترتي، خيال ضوئي على شكل خيال الظل لمجموعة ألوان غامقة ارتسمت على الحائط الذي سرت جانبه، والمفارقة كانت أنني لم ألمح باباً أو نافذة يشيان بوجود ساكنين هنا، لكن ثمة صوتاً غليظاً لكن بشكل خفيف أرعبني وقال عبارته المشهورة (شبيك لبيك)، لألمح الخيال ثانية أي ذلك المزيج من الألوان التي بدت كلوحة تشكيلية لم أستطع تفسيرها أبداً.. ذلك الصوت جعل تنفسي يخترق الرقم القياسي لتبدو ملامح القلق على وجهي ويتلعثم لساني، رغم أن طبيعة الصوت كانت بشرية.
أسندتُ ظهري على الحائط المقابل للخيال وأجلستُ نفسي على الأرض عنوة لدرجة أن الغبار تطاير لشدة وقع جلستي، وظننتُ نفسي أشاهد فيلماً سينمائياً وأنا المتفرج الوحيد الخائف المذعور، لكن الصوت عاد ثانية بشكل أقوى نسبياً ودخل صداه في أذني كالقنابل.
حاولتُ أن استرق السمع، لأفاجأ بالصوت يطلب مني المسير قليلاً إلى الأمام "إلى الأمام"، لم أفكر وسرتُ كما طلب مني بخطى متثاقلة حوالي خمس عشرة خطوة، وإذا بصوت قدمين يسرعان من ورائي، لم أتمكن من النظر لعدم قدرتي على ضبط حركة رأسي.
فتحتُ عيني وأنا في ذلك الموقع مستلقياً على ظهري وثمة أشخاص في الحارة يتمنون لي السلامة والتعويض السريع، لم أفسر وجوههم التي بدت هلامية حتى أصواتهم تداخلت في أذنيّ.



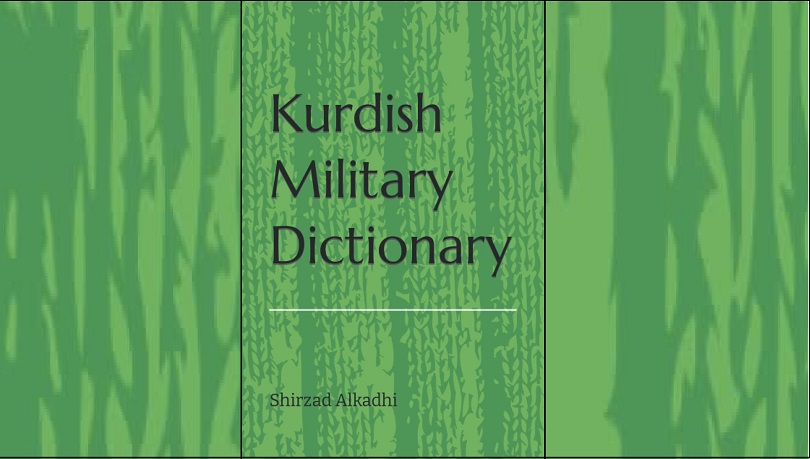





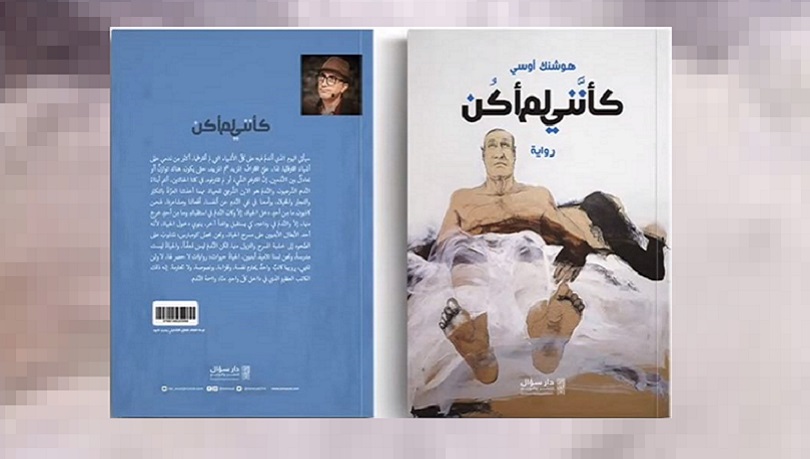





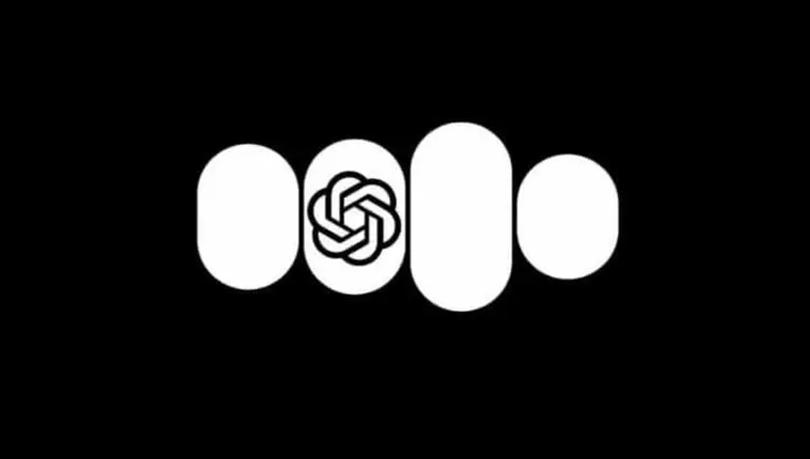

0 تعليقات